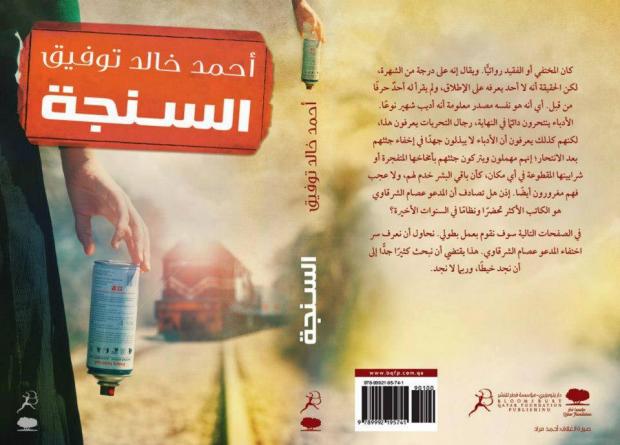لأنها واقعية جدا، لأن شخصياتها مرسومة بدقة مفزعة، لأن البشر يريدون الهرب من الواقع، والتحليق بعيدا في الخيال حتى لو كان خيالا مرعبا أو ديستوبيا مستقبلية بعيدة، على أن يثبتوا أقدامهم أكثر إلى الأرض، لأنني بكيت عندما أنهيتها، بعدما عرفت البطلة، عرفتها حقا، قابلتها وتحدثت معها، رأيتها من قبل في وجوه الفتيات البسيطات اللاتي أتعامل معهن كل يوم، في محلات الملابس، عند الكوافير، على المقهى يسرن محملات ببضائعهن اللاتي دفعن ثمنها بأقساط لبيعها إلى العابرين، عرفتها في مرآتي، وفى وجوه صديقاتي، وبنات عائلتي، إنه القهر، والفقر، والبؤس والخذلان والإحباطات، إنها السنجة، رمز لثقافة المجتمع حاليا، رمز لجيل يحل مشكلاته بالقوة، والفهلوة، ومشّى حالك، بالتشويح في الشوارع، وفى افتعال الخناقات وفضها، السنجة هي تعرية كاملة لمجتمعك ولنفسك أمام عينيك، إنها صادمة فعلية وقاطعة يرفض عقلك الاعتراف بها، فتنبذها، وتتجاهلها، وتغمض عينيك عنها.
هناك «تريند» راج في الأعوام التي تلت الثورة يستخف بأي عمل فنى أو أدبى يتحدث عن هذه الفترة الهامة في تاريخ مصر سواء اتفقت أم لم تتفق معها، لذا هاجم الجميع السنجة، معتقدين أن أحداث الثورة أقحمت في الرواية، لم يعرفوا أن الرجل لم يُقحم الثورة، هذه الرواية تمثل الثورة ذاتها.. فمثلها تركتنا في نفس الحالة من المشاعر المتداخلة.. حزن- إحباط- اكتئاب- استخفاف- لا مبالاة، وتشاؤم مطلق.
يلعب د.أحمد على التفاصيل مرة أخرى.. تفاصيل هذه الشخصيات الهامشية التي ربما لا يهتم بهم الكثيرون.. حتى في الأدب المصري والعالمين الذي يتم تناول الشخصيات المهمشة بشكل أحادي اللون.. إما الأبيض أو الأسود.. إما الفقير الطيب الذى يُعلى من قيمة الفقر أو الفقير الشرير الذى أخذ الفقر ذريعة لشره.. هنا لا يحدث هذا.. جميع الشخصيات رمادية اللون.. جميعها تستطيع أن تحبها وتكرهها.. جميعها صادفتها كثيرا ولم تهتم بملاحظة بؤسها الخفي أو حتى خشونتها الظاهرة.
أعرف أماكن بنفس وصف دحديرة الشناوى فى بلدى طنطا.. ربما لهذا تخيلت جيدا مزلقان القطار والجسر والقمامة على الجانبين وعربة الفول الواقفة والرجال الذين يقضون حاجتهم وظهرهم للقضبان أمام الجميع.. فتحة السور التي تسمح بالمرور إلى شارعين لا يفصل بين بؤسهما سوى قضبان القطار.. مررت بنفسي على هذه القضبان، قرأت بنفسي كلمات كتبت "بالاسبراى" لا أعرف من كتبها وماذا تعنى، ربما كانت كلمة السنجة من بينها ذات يوم.
أعرف تماما عم يتحدث الدكتور.. لذا كان حزني مضاعفا.. ربما قابلت عفاف في محل الطرح أو الكوافير أو محل تنظيف الدجاج بالفعل.. ربما لم أعرها اهتماما، بل وتحدثت بصورة غير لائقة عن بهرجة حجابها وضيق التنورة وعبوسها الدائم.. ربما لم أهتم بمعرفة شيء عن أحزانها وقهرها الدائم المختفي خلف كلمة وتنويعاتها: السنجة- السرنجة- السيجة- السرجة.
عفاف التي ذبحت مرتين، مرة أثناء ختانها طفلة والثانية في مشهد اغتصابها ضمن الانفلات الأمني الحادث وقت الثورة، هي رمز لكل التشويه الذى يحدث لنساء هذا المجتمع، ورجاله أيضا، يمكننا أن نضع عفاف كالشخصية النسائية الأهم في الأدب المصري هذا العصر بكل تأكيد، إنها الوطن المنتهك، الذى لم يحمه أحد، ولا حتى من يحبونه.
هناك خط عبقري يستحق التوقف عنده، شخصية إبراهيم أبو غصيبة التي سبق وظهرت في قصة قصيرة للدكتور نُشرت بـ«الدستور» القديم بعنوان «طفق ينتظر» ثم نشرت من جديد في مجموعة «الآن أفهم».
كانت هذه القصة الأشد رعبا على الإطلاق.. ربما لفرط واقعيتها لم يقرأها أحد بالاهتمام المناسب، أو يفهمها أحد بالطريقة الصحيحة.
في رأيي، يصلح هذا الخط كرواية مستقلة، ولكن وجوده في رواية السنجة لم ينتقص منه.. الرجل الذي يعيش حياتين لا يعرف أيتهما واقعه من حلمه، إنه يعيش في دحديرة الشناوى وسط البؤس والفقر والمرض، الرجل يحتضر بمرض الكبد، أطفاله شياطين صغار، زوجته لا تكف عن الشكوى، يعبر مستنقعات في طريق خروجه من منزله، لكن عقله وأفكاره في عالم آخر مرفه، زوجته تشبه العارضات، إنه بأكمل صحة وأوسم هيئة، بيته جنة، وأطفاله ملائكة، أم أنه العكس؟ أم أنه حي، أم أنه ميت، هل شعرت بالفزع كما يشعر هو في كل مرة يستيقظ أو ينام ليجد نفسه في عالم آخر؟
الجميل أننا جميعا مررنا بمثل هذا الحلم، هذا الموقف، فماذا لو كنا نعيش في خيالنا، أو نتخيل واقعنا؟ رباه لو كنا جميعا كذلك فإنا لهالكون.. هذه من أكثر التخيلات رعبا للنفس ولا أدرى كيف استطاع د.أحمد تحمل الفكرة دون أن يصاب بالاكتئاب المزمن.
هذه رواية عظيمة.. رواية مرهقة كتابةً و قراءة رغم أسلوبها السهل الممتنع كعادة الدكتور.. رواية تستحق أن تصبح من أهم الروايات التي كتبت عما قبل وما بعد وأثناء الثورة رغم عدم خوضها الشديد أو الميلودرامى داخلها مثلما فعل الآخرون.
إنها رواية العصر الذى تحمل اسم رمزه، المشتتة بتعمد مثله، سواء شئنا أم أبينا، سواء رغبنا في الفرار من الواقع أم تفحصناه عن كثب، هذه الرواية لا تنبئنا بمستقبل مظلم مثل يوتوبيا أو ممر الفئران، إنها تنبهنا إلى واقع مر نعيشه ولا ندرك، نحن بالفعل نعيش في مجتمع السنجة، نحملها، نكتبها، نعترف بها، السنجة
-للأسف- هى ما نحتمى به، وما نخاف منه.
اليوم الجديد
نورا ناجي