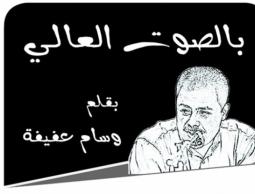وعاد الجميع من "دوار ملكة" ولم يعد أحمد!
هكذا كانت بداية وصول الخبر، ثم بدأ توافد الأقارب والمحبين، على بيت الدكتور محمود الرنتيسي فكان توافدهم هذا في غير موعده، مكفهري الوجه، باحثين عن عبارات تبرر تواجدهم في منزل الرنتيسي في هذه الساعة، كان ذلك أكبر دليل على أن أحمد لن يعود!
" سألتهم، ابني استشهد، أنا حاسس، عارف انه حيستشهد" فأخبروني أن هناك أقوالًا عن شاب مصاب اسمه أحمد، فتيقنت! ثم التزمت الصمت واحتسبته شهيدا" يصف الدكتور محمود الرنتيسي ما يشعر به في ذلك النهار، حينما اتاه خبر استشهاد أصغر ابنائه.
ثم خرج الدكتور محمود إلى المستشفى بصحبة الأقارب، يحمل في صدره وجع أب سرقوا قطعة من قلبه، ويضع فوق رأسه تاج فخر بأنه أصبح والد الشهيد، وبأن احمد هو من البسه تاج الفخر.
يقول: أنه آخر العنقود، صبوح الوجه، بهي الطلة، راجح العقل، يسبق أقرانه بكل شيء، وهذه الصفات الكثيرة، تجعل الله يصطفيه بالشهادة حتما.
ثم يبتسم وهو يحدق في صور ابنه التي وزعت في أرجاء الغرفة ويقول: " كان يوقظني لصلاة الفجر كل يوم، هو آخر أبنائي الأربعة وأكثرهم برا، ذكي، متفوق منذ صغره، أو كما تقول أمه: "ما غلبني في تربايته، ولا تعبني"
هل تعلم ما الذي يعنيه رحيل ابن كأحمد، انها انحناءة ظهر لوالدين يخفيان الوجع ودمعة الرحيل على ابن صوام قوام، يحمل من طيبة الحياة وخلقها الأجمل، حتى يكاد يرتجف صوت أمه وهي تصفه بقليل الكلمات قائلة:" الله يرضى عليه، حنون، متواضع، مثقف، كنت كل يوم أشعر بأنه سينال الشهادة".
أربعة أولاد وثلاث بنات، أصبحوا ثلاثة أولاد الآن بغياب أصغرهم عن الصورة، لحظة لا ينساها والده الدكتور محمود الرنتيسي، الذي كان شموخا رغم ألم الموقف، ثابتا رغم الاهتزاز الذي يحدثه في دواخلنا رحيل الأبناء، كنخلة باسقة تقبل خبر احمد، دون أي انحناء قائلا: الحمد لله، وتلك القوة لم يكن مصدرها قوة إيمان صاحبها فحسب، وانما توقعه في أي لحظة بأن يكرم الله ابنه بالشهادة، لأنه يستحق.
وفي لحظة وصول الخبر، تتزاحم كل الأفكار، بين حقيقة وكذب، بين مصدق وغير مصدق، ترفع أم أحمد هاتفها لتتصل على ابنها، لعله يرد لينفي كل توقعات رحيله، فيرد عليها شرطي من المستشفى الإندونيسي شمال القطاع، ويخبرها بأن صاحب هذا الجوال مصاب، فيحسم بذلك كل شك، وتتيقن الام الصابرة بأنها أصبحت الآن "أم الشهيد" .
وبينما جلست زوجته على أريكة تحتضن طفلتهما الوحيدة "مريم" بجانب صورة أحمد تبتلع ريقها حيث الكلمات تتزاحم على لسانها، فيرتجف صوتها وهي تعيد ذكريات اليومين السابقين، وكيف تحولت الحياة في غمضة عين الى واقع مؤلم، وحيدة هي وبين يديها قطعة لحم لا تتعدى الثمانية أشهر، لتواجه الحياة بدون أحمد.
ورغم توقعاتها المسبقة بأن هذا اليوم آت لا محالة إلا أنها فجعت، بكت، وتألمت، واشتاقت لرفيق دربها، وبدأت تصف قتامة الموقف والمشهد، الذي بدأ بتوقعاتها بأن أحمد سيغادر شهيدا في الخامس عشر من مايو، حيث بدأت معه صباح ذلك اليوم بهمة عالية ونية قوية للمشاركة في مسيرات العودة، كما كل الأسابيع السابقة التي كانت عائلة أحمد ووالديه وإخوته سباقين فيها إلى حدود غزة، متقدمين الصفوف الأولى في المطالبة بحق أهالي القطاع.
وفي تلك الدقيقة من الذكرى تصف لنا أم مريم صباح ذلك اليوم:" تغدينا مع بعض، أنا وأمه وأخوته، من طبخ صنعته أنا بنفسي، وأنا أقلب كلماته حينما استيقظت مريم مبكرة على غير عادتها فقال لها: "حتى أنت يا مريومة صاحية تودعيني"، وتضيف: " حتى شقيقته كانت تشعر بأن هناك مصابًا سوف يحدث وتحقق ما كانت تشعر به !
وببالغ حزنها وارتجاف صوتها تضيف: ثم سألت نفسي عن سبب كلماته تلك لابنته قبل أن يخرج، ونهرته عن استخدام لكنة الوداع في حروفه، فتلك السيرة تقتلني، وتذرف دمعي رغما عني، فأنا على علمي برغبة أحمد بالشهادة، او على يقيني بأنها ستتحقق، لأنها أصبحت أمنية من أمنياته، إلا أنني كأي زوجة كنت أخاف الفقد.
تضم ابنتها التي بدأ يغالبها النعاس إلى صدرها أكثر وتتذكر حسنات شهيد لن تغيب ملامحه عن الذاكرة، مقلبة في مناقبه التي لا تنتهي، واصفة حياة مرت كما الحلم لتقول: سنتان، كانتا أجمل سنوات عمري، لم أر كرما مثل كرمه، وابتسامة مثل ابتسامته، وحنانا مثل حنانه، كان أمنا لي وسندا، ثم رحل.